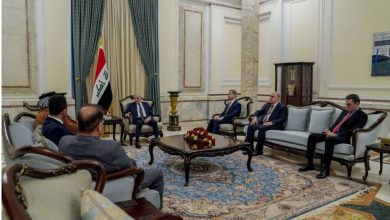سوريا في ظل تحولات المنطقة – الجزء الثاني
سوريا في ظل تحولات المنطقة – الجزء الثاني
محمد سيف الدين
سوريا
ما هو تأثير خيارات السياسة الخارجية الإيرانية بعد الاتفاق النووي على الأزمة السورية؟ وما هي خيارات المملكة العربية السعودية؟ وما هو أفق الواقع الميداني؟ ولماذا يتأخر الحل السياسي على الرغم من الانفراجات الدولية؟
بانتظار الحل السياسي
يدور الحديث في الأوساط المتابعة لتطورات الأزمة السورية ومسارات الحل السياسي المرتقب، عن تأخر هذا الحل، وبطء النتائج الايجابية المتوقعة من جراء الانفراج الدولي الذي أحدثه الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية. وتتراوح أسباب تأخر تلك النتائج بين ما هو داخلي مرتبط بالواقعين الميداني والسياسي، وبين ما هو خارجي مرتبط بمواقف الدول المؤثرة في الأزمة، وكيفية رؤيتها لمصالحها بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدايتها.
وبعد أن تناولنا في الجزء الأول، التغيرات التي تشهدها الساحة التركية وانعكاسات ذلك على سياستها الخارجية، وتحولات السياسة الأميركية تجاه المنطقة، وحدود الممكن بالنسبة لدولة الإرهاب الداعشية، نطرح في الجزء الثاني خيارات الأطراف الأخرى المؤثرة في مسار الأزمة السورية، من إيران التي أراحها اتفاقها مع الغرب، ومدّها بطاقة إيجابية تجاه دول المنطقة عموماً، والخليج خصوصاً، إلى المملكة العربية السعودية التي تواجه خيارات صعبة تجاه الأزمات التي دخلت طرفاً فيها، مع نقصان واضح في المرونة السياسية لدى قادتها الجدد، الأمر الذي يترجم ضبابية في سلوكها الخارجي. كما نبحث في معاني التطورات العسكرية الداخلية، واتجاهاتها، فضلاً عن محاولات سياسية لاختراق المشهد العسكري، وصولاً إلى حل بين الدولة السورية ومجموعات معارضة بوساطات روسية وإيرانية. فماذا عن خيارات إيران وأثرها في الأزمة السورية، بعد توقيع الاتفاق النووي؟
الخيارات الإيرانية بعد الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
لا شك بأن توقيع الاتفاق النووي يشكّل مفصلاً مهما في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وإذا ما ربطنا هذا المعطى بمجمل التبدلات التي تطال موازين القوى في النظام الدولي، فإنه يصبح تاريخاً مفصلياً في العلاقات الدولية المعاصرة، لما له من أثر في تبدل خيارات القوى الكبرى بالتعاطي مع دول تمردت على خيارات القوة الأعظم، رمز قيادة النظام العالمي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
فمن منطلق استراتيجي، وبمتابعة أحداث السنوات التي مرت منذ دخول القوات الأميركية إلى العراق في ربيع عام 2003، إضافةً إلى موقع إيران في سوق الغاز العالمي، والاحتياطات الهائلة التي تملكها، يتبين أن الخيارات الكبرى التي اتخذتها طهران أوصلتها لتكون القوة الإقليمية ذات الأهمية الأكبر بالنسبة للقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، متقدمةً على إسرائيل وتركيا، لأول مرة منذ العام 1979.
فمن منظور عالم الغد وحاجاته، وبالمقارنة بين الأهمية للاستراتيجية لكل من إيران وإسرائيل، يمكن رصد مجموعة من الفوارق التي تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية. أول تلك الفوارق اقتصادي، ويتمثل بالفارق الهائل في وزن الطرفين في سوق الغاز العالمي، راهناً ومستقبلاً، مع العلم أن مادة الغاز هي المصدر الرئيس للطاقة في القرن الحالي؛ وبما أن الطرفين لا يربطهما سوى العداء الشديد، فإن جمعهما إلى جانب قوى عظمى واحدة غير ممكن، إلا مع مراعاة حال العداء هذه، وتفضيل طرف على الآخر، وهذا ما يتوقع من السياسة الخارجية الأميركية التي ستضطر إلى تفضيل العلاقة مع إيران، على حساب تراجع في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، الأمر الذي أصبحت له علاماته القوية التي تتخطى الكيمياء السلبية بين أوباما ونتنياهو. من ناحية ثانية، وفي القيمية الاقتصادية أيضاً فإن حجم السوق الإيرانية والفرص التي تلوح أمام الغرب للاستثمار فيها، لا يقارن بالسوق الاسرائيلية التي لا تشكل أهميةً تذكر بالنسبة للاقتصادات الغربية. يضاف إلى ذلك أسباب سياسية وإنسانية، أبرزها الصورة المتعاظمة لإسرائيل في الغرب كدولة عنصرية لا تحترم القوانين الدولية والإنسانية، لتصبح بحسب الكثيرين ممكن يشكلون جزءاً من الضمير الغربي، الأولى بلباس ثوب “الدولة المارقة”، وعدم قدرتها على التعايش مع محيطها، ورفضها المتكرر لخطط السلام التي تعب الرؤساء الأميركيون من محاولة الظفر بإنجازها. وفي هذه المقارنة، يصب أيضاً في مصلحة إيران أن التحالف الأميركي الإسرائيلي مبنيً أساساً على قواعد عقيدية سياسية، لا تكافؤ مصالح فيها بين الطرفين، فضلاً عن أن هذا النوع من التحالفات ينتمي الى مرحلة الصراعات الأيديولوجية بين القوى الكبرى، وهي مرحلة انتهت، لتحل محلها العلاقات المبنية على المصالح المتبادلة في المرحلة المقبلة. وبالتالي فإن الأسس العميقة للتحالف الأميركي الإسرائيلي تهتز، الأمر الذي يثير جنون اللوبي اليهودي في أميركا. ولكن ذلك لا يعني تخلي واشنطن عن إسرائيل نهائياً وانتقالها إلى صفوف أعدائها، بل يعني تحديداً وحصراً أن أهمية هذه العلاقة بالنسبة لواشنطن تراجعت بشكلٍ حاد، يصحبها تراجع في قدرة القادة الإسرائيليين على ابتزاز سيد البيت الأبيض، ومن يترشح له.
وبالاستناد إلى ذلك، أعطت المفاوضات النووية ونتائجها نموذجاً على إمكانية الوصول إلى تفاهمات مع إيران بخصوص الملفات التي لم تشملها مفاوضات النووي، وأبرزها الأزمة السورية، ما يبرر عدم جنوح الإدارة الأميركية إلى مسايرة تركيا في فرض منطقة حظر جوي شمال سوريا، ونفيها مرات عدة الادعاءات التركية عن تفاهم على هذا الأمر بينها وبين واشنطن، وبالتالي فإن إيران تقدمت إلى موقع الشريك المحتمل في أذهان القادة الغربيين، وهم لأجل هذا “الاحتمال” يستعدون تباعاً لتقديم تنازلات في الملف السوري.
وبالتأكيد فإن هذه الرغبة الغربية تركز فقط على المصالح الذاتية لتلك الدول، وهي لا تستند إلى اقتناع بموقف المحور الذي ناصبوه العداء لسنوات، وأولى هذه المصالح مواجهة الإرهاب الذي باتت تشعر فيه الدول الأوروبية بصورةٍ ملموسة وداهمة، ولم يعد ممكناً التباطؤ في معالجة ارتداداته كونه يستفيد من القوانين الأوروبية لنشر أفكاره وتنقل أفراده في بيئة هادئة تشكل منطلقاً نحو الميدان السوري؛ من هنا فإن الرضوخ لفكرة التعاون الأمني بدايةً والسياسي تالياً، مع كل من سوريا وإيران، بات اليوم أمراً واقعاً بالنسبة لهذه الدول.
لقد استفادت إيران من تغير موقعها في نظر الغرب، لتطلق بعد الاتفاق النووي جهوداً دبلوماسية في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول مثلته زيارات مسؤوليها إلى دول الخليج، ومحاولتها التقرب منهم على قاعدة التطمين وتغذية أرضية المصالح المشتركة، بينما يتمثل الاتجاه الثاني في طرح مبادرة للحل السياسي في سوريا، في محاولة لاختراق الفشل الذي يصيب العملية السياسية بين الدولة والمعارضات.
ففي الاتجاه الأول، ركز وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته الى الكويت وقوف بلاده “إلى جانب شعوب المنطقة في قتالها تهديد التطرف والإرهاب والطائفية”، وهو بذلك بنى على الموقف الكبير الذي اتخذته القيادة الكويتيه بعد تفجير المسجد الذي راح ضحيته عدداً من المصلين من المسلمين الشيعة، وبذلك نزعت القيادة الكويتية فتيل احتراب مذهبي كان مخططاً لانطلاقه في البلاد. يضاف إلى ذلك، تركيز نائبه حسين أمير عبداللهيان على أن هدف بلاده هو التعاون مع الجيران حتى يعود الاستقرار الى الشرق الأوسط.
هذه التحولات في فرص ايران في المنطقة، دفعتها إلى المبادرة باتجاه إيجاد حلٍ للأزمة السورية، فقدمت مبادرتها التي بحثها عبداللهيان مع الرئيس السوري، وهي مبادرة تسير بالتوازي مع الجهود الروسية النشطة في السياق نفسه، حتى ان عبداللهيان تحدث في زيارته الى سوريا باسم إيران وروسيا حين قال: “طهران وموسكو لديهما مواقف مبدئية وراسخة في مجال دعم سوريا”، و”إن أي مشروعٍ للحل نطرحه يلقى المساندة الروسية”، مشيداً بـ”الدور المحوري للرئيس السوري بشار الأسد في الحفاظ على وحدة سوريا، وإدارته الحكيمة لإخراج بلاده من الأزمة”، وفق ما قال المسؤول الإيراني. واللافت في هذا السياق، أنه وبعد الاتفاق النووي فإن المبادرات التي تطرحها إيران، تلقى اهتماماً على مستوى دولي، وهو أمر جديد في مسار التعاطي مع إيران، وما لقاء عبداللهيان بستيفان دي مستورا في بيروت مؤخراً وبحثهما المبادرة الإيرانية، إلا مظهرا من مظاهر تغير وزن إيران في المنطقة وأبعد منها. لكن ماذا عن الدور السعودي المطلوب لإنجاح هذه الحلول؟ وأين تقف المملكة من مبادرات الحل السياسي؟
السعودية: “عدم يقين استراتيجي” دائم
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
إن حساب الخيارات السعودية في التعامل مع الأزمة السورية يظهر مروحةً كبيرة ممكنة من الخيارات، وفي كثيرٍ منها فائدة مؤكدة للمصالح السعودية في المنطقة. كما أن الدور السعودي مطلوب في سوريا وفي غيرها من ملفات المنطقة، وهو إذا ما تقاطع مع الموقف الإيراني قادر على تأمين الاستقرار في غير دولةٍ، وإلى حدٍ بعيد.
ولكن المراقب لأداء السياسة الخارجية السعودية، وفي الملف السوري على وجه الخصوص، يجد منسوباً غير مبرر من الإصرار على مقارعة التحولات التي تشهدها المنطقة، ونكران لتصديق التحولات الأكثر اتساعاً منها.
فهل تستطيع الرياض رفض الإرادة الأميركية والاستمرار بالسير عكس الأحداث السياسية؟ الجواب حتى اللحظة بالنسبة للقادة الجدد في الرياض لا يزال إيجابيا. ولكن ما هي مبررات هذا الاقتناع؟ وهل يكفي الموقف الفرنسي الساعي الى دخول قطار الحل وجني حصة من فوائد الحل، عبر التصعيد السياسي ضد سوريا؟ وهل يمكن الاستعاضة عن واشنطن بباريس؟
إن تراجع القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في اهتمامات الغرب عموماً والإدارة الأميركية على وجه التحديد، يمكن أن ينسحب على الحال السعودية، وخصوصاً إذا تنبهنا إلى تراجع القيمة الاستراتيجية للنفط مقابل الغاز، على المديين المتوسط والبعيد. فالدور الذي تلعبه المملكة حتى اللحظة في سوق النفط، لن يكون ممكناً في العقد المقبل، وعليه، فإن طموح السياسة الخارجية السعودية يجب أن يتناسب مع اتجاهات القيمة الاستراتيجية ومستجداتها.
إن الانخراط السعودي في حلٍ سياسي في سوريا، قادر بالضرورة على تأمين موقع مهم للمملكة في إدارة شؤون الشرق الأوسط، وهو موقع ليس بأقل من شريكٍ رئيسيٍ لإيران وسوريا ومصر، ولكنه بحاجةٍ إلى قرارٍ تتخذه الإدارة السعودية، وفق رؤية بعيدة المدى لمستقبل المنطقة وحاجات شعوبها، والأخطار التي تحدق بدولها، وهي في طليعة تلك الدول المهددة من هذه الأخطار.
فبالإضافة إلى الثغرة التي يمثلها موضوع الحريات في النظام السياسي السعودي، تعاني المملكة اليوم من تناغم عميق بين التربية الدينية الرسمية فيها، وبين الجماعات الإرهابية التي تهددها، فالمدرسة الوهابية تنتج بالضرورة أرضاً خصبة لزراعة نبتة “داعش” السامة، وطالما أن القيادة السعودية لم تتخذ القرار الجريء بإحداث تحول في التربية الدينية والانفتاح على التيارات الإسلامية الأخرى، فإن ثعباناً يكبر في حضن المملكة، وهو التهديد الأول لها.
إلى جانب ذلك، فإن الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الحاكمة يؤدي إلى فقدان التركيز الاستراتيجي، في لحظةٍ هي الأشد خطورة منذ تأسيس النظام في النصف الأول من القرن الماضي. وفي غياب مفهومٍ واضح للأمن القومي في الممكلة، تتعاظم الأخطار التي تحيط بها، ويندفع مسؤولوها إلى حروبٍ خاسرة لكل المشاركين فيها، باستثناء مصانع السلاح وتجاره في الدول التي تخاول الخروج من أزماتها المالية.
وفي موازاة ذلك، وبالرغم من الثروات الهائلة التي صرفت على بناء المدن والبنى التحتية، والتي تصرف أيضاً بكمياتٍ كبيرة على شؤون منعدمة الفائدة، لم تتمكن المملكة بعد مرور عشرات السنوات على تزعمها بيع النفط، من أن تبني اقتصاداً حقيقياً منتجاً يوازي اليابان أو ألمانيا أو إحدى الدول الأقل تطوراً من ذلك، بل تم التركيز على الفقاعات الإعلامية والاستثمار في أسواق المال الافتراضية، وفي القطاعات الخدماتية، وتعميم ثقافة الترفيه في مجتمعها، ما يبقي اقتصادها رهينة ببورصات مهددة في أية لحظة، فما الذي يمنع دولةً تمتلك كل هذه الإمكانات المالية من أن تبني صناعات ثقيلة تقيها شر نضوب النفط؟ وهي اللحظة الآتية في زمن منظور.
إن الانطلاق من هذه النقاط، يمكن أن يوضح الأسباب التي تدفع بالمملكة إلى التمسك بخيارات غير مربحة في الأزمة السورية، في وقتٍ تقف فيه “داعش” على حدودها، بل تفجر داخل أراضيها. ويمكن اختصار هذه الأسباب بنقصٍ حاد في منسوب المرونة السياسية، وحالة من “عدم اليقين الاستراتيجي” الدائم، على الرغم من انفتاحها المستجد على موسكو، وما يحمله من بداية تغير في العقل الاستراتيجي السعودي، الذي يستشعر الوعي والمتغيرات ولكن تشده إلى الخلف قلة المرونة وشخصنة مصالح الدولة.
وفي هذا الإطار، تراهن روسيا على مدٍ بطيء لجسور المصالح مع السعودية فتستقبل الملك سلمان في الخريف المقبل، في الوقت نفسه الذي يحارب فيه حلفاؤها”جيش الفتح” في شمال سوريا وباتجاه الغرب، فاتحة بذلك المجال أمام مصلحتين مهمتين لها، ولكن تقعان على طرفي نقيض.
إن تحصيل المكاسب السريعة بوسائل دعم القوى الطائفية يعبّر عن خلل في الرؤية الأمنية الاستراتيجية، واحتمالات انقلاب السحر على الساحر، وهذا ما يجب أن يكون بديهياً لصناع القرار في أي من دول المنطقة.
ولكن اتجاهات السياسة السعودية بما يخص الأزمة السورية، تشير إلى أن الاستدارة الكاملة على ضوء الوعي للموقف والموقع، ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت. يعيب السياسة السعودية ميل مسؤوليها إلى شخصنة قضايا تخص شعوباً شقيقة، وانعدام الواقعية السياسية، ولا يتوقع أن يؤدي هذا النهج إلا إلى مزيد من الدماء في المنطقة. وعليه، فإن المخاطرة بكل شيء لكسب شيءٍ غير مضمون، يبقى علامةً فارقة في السياسة السعودية المستمرة تجاه سوريا.
أفق المعركة في سوريا في ظل تحولات المنطقة
افق المعركة ما يزال مفتوحاً
بعيداً عما سبق، تستمر الحرب الميدانية بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والمجموعات المسلحة غير القابلة للاحصاء من جهة ثانية. ووفق مسار الأمور، فإن نتائج هذه الحرب ووقائعها الميدانية هي وحدها التي تخفف من حدة الصراع السياسي على سوريا، بمعنى أن اشتداد وطيس المعارك والقدرة على حسمها، يؤدي إلى تحريك الجمود في مواقف الأطراف المختلفة حول الحل السياسي.
فالسنوات السابقة من عمر الأزمة أثبتت أن المعارك الكبرى التي تمت فيها السيطرة أو استعادة المدن المركزية، هي التي غيرت في المسار السياسي وفي توقعات الأطراف من الحل المنشود، ويراهن السوريون في هذا الإطار على جيشهم الذي على الرغم من خسائره الكبيرة منذ 2011 وحتى اليوم، تمكن من حسم المعارك الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، فاستعادته لحمص والقلمون ومعظم مناطق الغوطة، جعلت من العناوين السياسية التي طرحتها قوى المعارضة في فترة سابقة، عناوين منفصلة عن الواقع. فضلاً عن أن اتجاهات الأمور الميدانية تشير إلى بقاء نوعين من القوى الجدّية على الأرض السورية، الجيش والإرهاب. ولكن ماذا عن شبح التقسيم؟
ذهب الكثير من المتابعين للأزمة إلى توقع تقسيم سوريا في المرحلة المقبلة، مستندين بذلك إلى بطء سيطرة أي من الأطراف المتحاربة على مناطق أعدائهم، ومحافظة معظم القوى على مساحة سيطرة متقاربة منذ بداية 2014، مع وجود بعض الاستثناءات، أهمها في منطقة القملون. ولكن ما يضعف احتمالات التقسيم إلى أدنى مستوى هو عدم قدرة أي من الأطراف التي تسعى إليه على فرضه، ذلك أن “جبهة النصرة” أو “جيش الفتح” والمجموعات التي يتضمنها، و”داعش”، لا يمكن لهم فرض تقسيم يسيطرون بموجبه على جزء من الأراضي السورية، بموافقة الدولة، أو حتى بموافقة الدول الكبرى عندما تصبح الحال طبيعية ويعود السلم إلى البلاد، ومعنى ذلك أن هذه المجموعات الإرهابية تشكل حاجةً للأطراف الخارجية اللاعبة في الساحة السورية، حصراً في أوقات الحرب. كما أن الطرف الآخر وحلفاءه، وهنا نتحدث عن روسيا تحديداً، لا يناسبهم سوريا مقسمة على الإطلاق، وهي نتيجة كانوا ليحصلوا عليها منذ السنة الأولى للأزمة لو أرادوا، ولكن دعمهم للنظام الرافض للتقسيم ينطلق من حاجتهم إلى الدور الذي تلعبه سوريا في المنطقة لإقامة التوازن بينهم وبين القوى الكبرى الأخرى، في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى.
يضاف إلى ذلك تماسك معظم العناصر التي تضمن وحدة البلاد، ومنها بنية صلبة للجيش، إدارة عاملة طوال سنوات الأزمة، جسم دبلوماسي نشط ومتماسك، تحالفات خارجية مؤثرة جداً، وتملك مختلف وسائل تعطيل الحلول المفروضة من الخارج، من الفيتو إلى الميدان، سيطرة على قلب البلاد ومناطقها ذات الأهمية المرتفعة، وأهم من ذلك كله، عقل قيادي بارد قادر على الصبر لتلقي النتائج الأفضل، واستثمار توتر أعدائه في انتزاع مكاسب نوعية منهم.
في الإطلالتين الأخيرتين للرئيس السوري تحدث بشكلٍ شفاف عن حال الجيش، قائلاً إن حلول التعب على عناصره أمر طبيعي، ولكنه أكد أن ذلك لا يؤثر في فرص النصر. هذه الإشارة تعبر تماماً عن الطريقة التي تدير فيها القيادة السورية الأزمة على المدى الاستراتيجي، وربما تعبر لاحقاً عن هوية المنتصر في الحرب الدائرة.
المصدر: الميادين نت